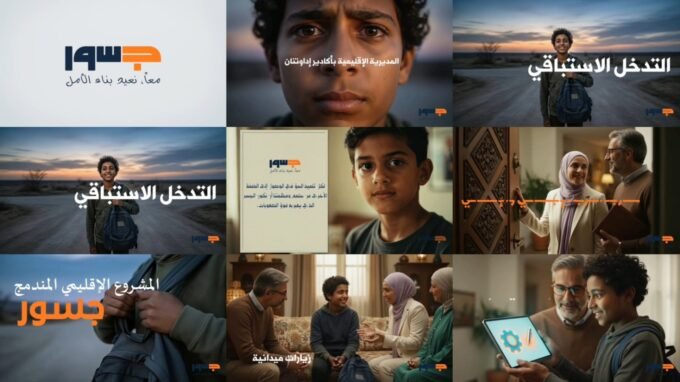“بريد تيفي”: عبد اللطيف وهبي
نص الفصل 37 من الدستور أنه على جميع المواطنين والمواطنات احترام الدستور، علما أن احترام القوانين هو تصرف طبيعي داخل أي مجتمع ديمقراطي، مما يطرح السؤال حول جدوى التنصيص على ضرورة هذا الاحترام إذا كان تحصيلا للحاصل، فهل يعني أن واضعي الدستور تخوفوا من عدم احترام
القانون الأسمى؟ وهذا الاحترام الذي لا يعني فقط الالتزام بقواعده في الحياة اليومية للمواطنين والمؤسسات، بل يقتضي التعامل معه بما يتطلبه من واقعية ومصداقية وجرأة خاصة عند تفسيره وتحليله ومحاولة فهم دلالات نصوصه، بعيدا عن التعسف والقراءات السياسوية والظرفية.
فكرة الدستور كنتاج وطني ديمقراطي وتراث إنساني تجعله لا يقوم على مبدأ واحد، له مفعول شامل، بل يستوعب تطلعات المجتمعات المعاصرة المركبة وتعقيدات الحياة الاجتماعية والسياسية التي تضم أفرادا ومواطنين معقدين ومترددين في تصرفاتهم، وهذه التعقيدات تضمنتها الدساتير ((التي تنص على الحرية وفي الوقت نفسه المساواة، الحقوق الجماعية المحافظة على التقاليد الأخلاقية والثقافية وفي الوقت نفسه إعادة النظر فيها)) كما قال أحد الفقهاء الدستوريين.
أما في الدستور المغربي فإن المسار يعكس تجربة المغاربة وتاريخهم الخاص، سواء ما يهم العلاقة فيما بينهم أو في علاقتهم بالحكام، بل حتى ممارستهم لعقائدهم الدينية وشعائرهم، و يتضمن توجيهات مستقبلية وينأى بنفسه عن الدخول في التفاصيل، متسما بالعمومية والاقتصار على المبادئ.
فهندسة النص الدستوري تؤكد تفاعله مع الواقع، دون أنه لا يخضع له حتى لا تصبح هندسته أسيرة وضع سياسي ظرفي، فالدستور لا يوضع للمرحلة التي يصاغ فيها، ولكنه يوضع لبناء مرحلة زمنية طويلة مستقبلا، ومن تم يستند على رؤية فلسفية وأخلاقية قد يطالها الغموض، فقط لأنها لا تغرق في تفصيلات وتدقيقات قانونية من شانها أنها تجازف باختزال دلالته.
وبارتباط مع ما نعيشه اليوم من وضعية سياسية ملتبسة بسبب تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة، نجد أن الحزب الحاصل على المرتبة الأولى في نتائج الانتخابات الأخيرة، يعتبر أن أي تفسير للنص الدستوري مخالف لتفسيره الذاتي يعد مساس بحقه في إدارة الشأن العام، وهذا الموقف الصادر عن الحزب الأول في حقيقة الأمر هو تصرف لا دستوري، وموقف غريب قد تترتب عليه عدة نتائج قانونية ودستورية.
فنحن نعيش اليوم أمام حالة سياسية خاصة، حاولت كل جهة القيام بتفسير للفصل 47 من الدستور حسب هواها أو حسب ما تسعى نحوه، خاصة وأن الفقهاء الدستوريون يعتقدون أن وجود أي إشكال في نص دستوري والتوجه نحو تغييره لا يعود فقط إلى اختلافات في النظرية الحقوقية بقدر ما يعود إلى التقديرات السياسية للفاعلين مما يطرح سؤالا حول مدى اتسامهم بالنضج والنظرة إلى المستقبل حتى يكون التفسير ليس صادر عن سياسي ذي مصلحة ذاتية وآنية، ولكن عن رجل دولة يساهم في تأسيس الدولة للحاضر والمستقبل.
فعملية تفسير الدستور يفترض فيها أن تكون وسيلة لحوار سياسي تساهم فيه جميع الأطراف التي من واجبها أن لا تستحضر معطيات المرحلة الظرفية والمكسب السياسي الآني، ولكن من واجبها أن تراعي في تفسيره ضرورة الحفاظ على تلك الهندسة الدستورية وتثمين دور كل مؤسسة على حدة لتكون فاعلة بشكل إيجابي في الحفاظ على المكتسبات الدستورية التي توافق عليها المغاربة عند تصويتهم على الدستور لحظة الاستفتاء.
فالأحزاب السياسية التي تتصارع دستوريا تقوم بدور الوسيط بين الدستور والمغاربة، ويتم تفسير النص بناء على القيم والتوافقات التي التزم بها الجميع شعبا ومؤسسة ملكية وأحزابا في لحظة التصويت على الدستور، مما ينتج عنه حسن أداء المؤسسات الدستورية وتجنب شللها واتقاء الأزمات السياسية، وهذا يتطلب نوع من اللباقة والمرونة السياسيتين اللتان ستنعكسان إيجابا على المنظومة الدستورية كلها، كما ستنعكسان بشكل إيجابي وعملي على المؤسسات الدستورية وعلى كل الهيئات باختلاف مكوناتها.
إن هذه المسؤولية التاريخية تتطلب أن نتصف بالجرأة في بناء موقف وطني واضح اتجاه الدستور، هذا الأخير الذي استطاع أن يستوعب الكثير من الاختلافات، ولكنه كذلك حاول أن يؤسس لتطورات مستقبلية تاركا المجال أمام مساهمة الفاعلين في كل مرحلة لإعادة تركيب مكوناته الفكرية والمؤسساتية، وإزالة الغموض الذي قد يبدو لنا أنه ينطوي عليه.
غير أن الذين يعتقدون أن هذا الفصل أو ذاك يتسم بنوع من الغموض البنيوي لم يدركوا أن هذه النصوص ليست منغلقة أو متقوقعة على ذاتها، بل هي في مجملها تكمل وتفسر بعضها البعض، لكون المنظومة الدستورية تستهدف خلق نوع من الاستقرار لنظامنا السياسي ومؤسساتنا الدستورية، لتسعى إلى استيعاب متطلبات المجتمع بكل تعقيداته وما يحتاجه من ضمانات لحقوق الأفراد والمؤسسات.
وبناء عليه حين ترتفع أصواتا سياسية ملوحة بأننا نعيش مرحلة تتسم بالأزمة السياسية، فهي تصدر أحكاما ساذجة مفادها أن سبب الأزمة نابع عن طبيعة الفصل الدستوري من منطلق أن كل واحد يقرأه في حقيقة الأمر بناء على نتيجة يستهدفها مسبقا وليس عن محاولة فهم النص الدستوري من خلال ربطه بفصول أخرى بإعمال النزاهة الفكرية بعيدا عن منطق الربح أو الخسارة، محررين أنفسنا من الانزواء في مصلحة مرحلية لاقتراح فهم انفراجي للنص الدستوري وخلاف ذلك هو في حقيقة الأمر ليس سوى تقزيم للفصل الدستوري ليخدم جيلا سياسيا مرحليا وفي نفس الوقت يصنع أزمة سياسية تمتد في التاريخ وفي السياسة، لذلك فالسياسيون المغاربة وهم يفككون حاليا معظلة أزمة تشكيل الأغلبية الحكومية غالبا ما يقفون عند الكلمات الأولى للفصل 47 من الدستور، وبالتالي دون قراءتها في تقاطع مع مكونات الفصل ذاته ومع الفصول الأخرى، علما أن كل تفسير في حقيقة الأمر هو نتاج قياس منطلقه الأساسي طبيعة النظام السياسي الذي يستهدفه الدستور والحفاظ على استمراريته استنادا على توافق الجميع حوله، أي ندستر ما توافقنا حوله.
إن مقاربة هذه “الأزمة” من خلال ما نص عليه الفصل 47 من الدستور تفرض علينا أولا ضرورة الانطلاق مبدئيا من كوننا أمام نص ينظم عملية سياسية تضم أطراف معينة كما تتضمن شروطا محددة، من حيث الأطراف هما:
-أولا: جلالة الملك.
-ثانيا: الحزب المتصدر لنتائج الانتخابات.
وأما من حيث الشروط فهما:
– أولا: تصدر نتائج الانتخابات
– ثانيا :وعلى أساس نتائجها.
وعليه يجب أن نحدد طبيعة هذه الأطراف وطبيعة مركزها من خلال المنظومة الدستورية كلها لنطرح السؤال التالي: ما هي الطبيعة المؤسساتية لجلالة الملك عندما يقوم باختصاصاته وفقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور؟ أولا: هل يقوم بها بصفته رئيسا للدولة أم ثانيا: بصفته أميرا للمؤمنين حامي حمى الملة والدين؟ أم ثالثا: باعتباره الضامن لدوام الدولة واستقرارها؟ أم رابعا: بصفته الساهر على حسن سير المؤسسات الدستورية؟ أم خامسا: بصفته حكما أسمى لصيانة الاختيار الديمقراطي؟ أم سادسا: كل هذه الاختصاصات بتقاطعاتها وما تنتجه من المسؤولية ومن السلطة ومن التقرير ومن التقييم ومن التحكيم؟.
إن الدستور المغربي منح اختصاصات متعددة لجلالة الملك من مواقع مختلفة، تارة كمسؤول وتارة كضامن، كمسؤول عندما يقرر وكضامن عندما يحافظ على وضع سياسي ما أو على التمتع بحقوق معينة، فالفصل 47 من الدستور مثلا ينص على صلاحيات باعتباره رئيسا للدولة، والفصل 41 يمنحه صلاحيات دينية، والفصل 42 يربط صفة جلالة الملك برئيس الدولة ويمنحه العديد من الاختصاصات التي أشرنا إليها سابقا، وصفة الملك هي العنصر المشترك بين ما له من صلاحيات دينية في الفصل 41 وسلطات مؤسساتية في الفصل 42.
وعليه فالقيام بالفرز في الصفات ليس مسألة لغوية كما يعتقد البعض، ولكن لكل صفة دلالتها الدستورية تكمل بعضها البعض ولا تلغي إحداهما الأخرى، بل تساهم كلها في تأسيس سلطة اسمها “السلطة الملكية”، فالملك أميرا للمؤمنين، أي أنه هو المسؤول على أمر المسلمين جميعا وهم المغاربة، وإمارة المؤمنين كما يفسرها المنظرين الدينيين أو أصحاب الفكر السياسي الإسلامي هي ما يملكه جلالة الملك من سلطة دينية للسهر على أمن وسلامة المسلمين وحقهم في ممارسة شعائرهم وحماية أعراضهم ودمائهم وضمان سير عيشهم، وكذلك غير المسلمين الذين يقطنون فوق أرض الوطن.
إضافة إلى ذلك فالفصل 42 من الدستور عندما ينص على دور جلالة الملك كرئيس للدولة فهو يمنحه سلطات لإدارة الشؤون الدنيوية لفائدة المواطنين مسلمين وغير مسلمين، و السهر على حسن سير المؤسسات لتوفير الخدمات للمواطنين، وذلك في إطار مسؤولية الدولة اتجاه مواطنيها، وعليه سنقوم بتفسير الفصل 42 من منطلقي إمارة المؤمنين ورئيس الدولة لاستحالة الفصل بينهما.
فالمنطلق الديني يجعل سلطة جلالة الملك سلطة مبنية على المصلحة العامة، وأينما كانت المصلحة فتم شرع الله، وعليه إذا ارتأى جلالة الملك أن يوجه تفسيرا لنص دستوري فهي قرينة على استهداف الوصول إلى المصلحة التي تهم المؤمنين جميعهم ولا تهم حزبا من المؤمنين دون غيره، فولي الأمر من المنظور الإسلامي هو الملم بالمصلحة، وهو المسؤول على الإتيان بها، وهذا هو سند سلطته في تقدير مصلحة المسلمين والقول بها والعمل بها، وهذا التقدير سيستمر مادام ليس هناك خروج عن الأحكام الشرعية للدين، أما الخروج عن السياسية فهذا شأن آخر تحكمه موازين القوى وطبيعة المصلحة من خلال التقييم الخاص لجلالته، ففي السياسة لا توجد أحكام نهائية وفاصلة في الموضوع و الزمن.
وعليه كيف ما كان قرار جلالة الملك في تفسيره للفصل 47 فإنه سيكون تفسيرا تستحضر فيه صفة إمارة المؤمنين لاستحالة الفصل، وهذه السلطة من المفترض أن تكون مصدرا من مصادر سلطة الإمارة، ويبدو أن هذا الموقف يساير موقف ومرجعية الأحزاب “الإسلامية” اتجاه ولي الأمر.
هذا على مستوى الأطراف أما على مستوى الشروط فنلاحظ أن الفصل 47 من الدستور، وضع شرطين منفردين في عملية تعيين رئيس الحكومة وهما:
– أولا: أن يكون من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب.
– ثانيا: وعلى أساس نتائجها.
ومن ثم فالسؤال الذي يطرح نفسه هل يمكن اختزال الفصل 47 من الدستور في الشرط الأول، أي في الحزب الذي تصدر نتائج الانتخابات فقط؟ وبالتالي نغض الطرف على فقرة الشرط الثاني، والتي لا يمكن أن يكون واضعو الدستور قد أضافوها اعتباطيا أو أن تكون من الحشو أو تحصيل حاصل، بل إن الدستوريين حينما أصاغوا هذا النص كانوا مدركين أن فقرة الشرط الثاني سيكون لها حضور في التطور الدستوري في المغرب على مستوى تثبيت المؤسسات الدستورية، لذلك فهو شرط مستقل بذاته قد يجد دلالته في فصول أخرى ويمكن تفعيله كمدخل ثان عندما تطرح قضية تشكيل الحكومة وما يؤكد ذلك أن فصول الدستور تكمل بعضها البعض، و فهم نصوصه يستند على تماسك مكوناته، ضمانا لحسن أداء المؤسسات الدستورية وتجنبا للسقوط في الشلل والأزمات؟.
إن اصطدامنا بأية أزمة سياسية تفرض علينا إيجاد حل دستوري لها والذي يجب أن يتسم بالديمومة والمرونة، وفي حالتنا هته وجب إيجاد حل لأزمة حزب متصدر لنتائج الانتخابات لكنه عاجز عن تكوين أغلبية حكومية، مستبعدين مبدئيا حل إعادة تنظيم الانتخابات باعتباره حلا غير مضمون، فهو حل قد يرضي أصحاب الحسابات الانتخابية لكنه لن يؤدي مطلقا إلى تطور المنظومة الدستورية التي يكون لها انعكاس إيجابي على المجتمع والقوى السياسية بمختلف مكوناتها ويحد من تقهقرها وتراجعها.
إن الاتجاه نحو خيار إعادة الانتخابات قد ينتج عنه إفراز أزمة مماثلة حتى ولو أعدنا الانتخابات لعدة مرات، فنصبح في وضعية لا تتحملها لا السياسة ولا الاقتصاد وقد ينتهي بنا المطاف لأن نكون سجناء اجتهاد من الصعب التراجع عنه مستقبلا.
وإذا كان لا يمكننا العلم بنوايا واضعي الدستور، فإن المصوتين لا تهمهم تلك النوايا، بل تعاملوا مع الفصل كما هو أو كما تصوروه، مدركين أن أي فصل قد يطرح إشكالات دستورية مستقبلا رهين بإيجاد حل له استنادا على ثقتهم في نضج المكونات السياسية والمؤسساتية لإيجاد حلول للأزمات من خلال تفسيرات لنصوص دستورية، لذلك لم يهتموا بظروف كتابة القواعد الدستورية، بل انصرف اهتمامهم إلى بناء نظام دستوري يضمن حسن سير المؤسسات و ديمومتها.
ولأن الدستور يكمل بعضه البعض، فمن الواجب أن نؤكد على أن لجلالة الملك وفقا للفصل 42 من الدستور الصلاحيات بإيجاد حل عملي مستندا في ذلك على تفسيره للنص الدستوري، ليضمن حسن سير المؤسسات الدستورية باعتباره الساهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات الدستورية، أي صاحب الفصل في الخلافات الدستورية الخارجة عن اختصاصات المحكمة الدستورية مثل حالتنا هته من غير أن نتجاهل أن الدستور هو الهدف، بل الهدف يكمن في مدى قدرته على تنظيم سير المؤسسات الدستورية بسلاسة ومرونة.
لهذا نرى أن التعامل مع الفصل 42 سيكون هو المدخل الحاسم للنقاشات الدستورية موضوع “الأزمة” الحالية، وقد يقطع مع المزاجية البراكماتية الضيقة في تفسير الدستور، بل سيقطع الطريق على كل من يفسر الفصل الدستوري انطلاقا من نتيجة الفعل السياسي الذي يتوقع أنه سينتج عن تفسيره، بل إن اعتماد جلالة الملك على إعمال وقراءة كلية لكل فصول الدستور ستكون مدخلا مناسبا للقيام بإجراء دستوري آخر وقد يعتمد فيه على فهم أوسع للفصل 47 داخل المنظومة الدستورية كلها.
و بغض النظر عن ما سيقوم به جلالته في حالتنا هته دعونا نقوم ولو بنوع من المجازفة بتفسير الفصل 47 في تقاطعه مع الفصل 98 من الدستور، ذلك أن هذا الأخير ينص على أن عدم توفر أغلبية حكومية داخل مجلس النواب يمكن حل هذا الأخير دون احترام آجال “السنة”، وسنلاحظ أن الفصل 98 قد نص على شرط عدم التوفر على أغلبية حكومية، وكان من الممكن أن يصاغ النص الدستوري بطريقة صريحة تفيد ما نص عليه الفصل 47، أي في حالة عدم تمكن الحزب الذي تصدر النتائج الانتخابية من تكوين أغلبية حكومية، لكنه بخلاف ذلك نص على المطلق، وهي عدم توفر أغلبية حكومية، أي أن هذه الأغلبية لم يقرنها النص بالحزب الأول، فهل هذا يعني أن الأغلبية يمكن أن تكون موضوع قيادة من طرف حزب لا يحتل الصدارة؟ أم أن وجود الأغلبية مرتبط وجوبا وعدما بوجود الحزب الأول على رأسها، وإلا لا نتخيل وجود أغلبية بشكل مطلق دون الحزب الأول خاصة أن فشل الحزب المتصدر للانتخابات(كما قلنا) لا يعني الذهاب إلى الانتخابات من جديد، لأن هذا الخيار فيه نوع من المجازفة بتكرار الحالة نفسها إلى ما لا نهاية؟.
ثم من جهة أخرى فالفصل 98 من الدستور حينما نص على الأغلبية الحكومية فإنه يقوم بإعمال الفصل 47 من الدستور في جزءه الآخر، فيستحضر عنصرا جديدا وهو الشرط الثاني “وعلى أساس نتائجها” الذي أشرنا إليه سلفا، أفلا تعني هذه الجملة نوع من التناوب في التعيين وفي قيادة الأغلبية؟ أي أن الامتياز الذي للحزب الأول مرهون بالأسبقية في التعيين وليس في الوجود أو عدم وجود الأغلبية أصلا.
وبقراءتنا للفصلين 47 و 98 بشكل متقاطع يسعفنا في استنباط قاعدة دستورية كاملة تضمن لنا حسن سير المؤسسات الدستورية، بل تضمن لنا نوعا من التوازن بين القيم، وتجعل تفسير الفصلين في ارتباطهما خاضع لمعايير موضوعية مفادها أن الدستور منطلق لحل الأزمات وليس مجالا لخلقها، فالدستور يتجادل مع الواقع لبناء المستقبل وبشكله البناء.
وعليه لنقم بصياغة الفصلين بإدماج بعضهما البعض لأننا أمام وضعيتين متشابهتين لكنهما مختلفتين في طبيعة الشروط السياسية، يلتقيان فقط فيما يملكه جلالة الملك من سلطة التعيين، غير أنهما يفسران بعضهما البعض استنادا على القياس كقاعدة للتفسير، فإذا كان الفصل 47 يعرف أزمة في التنفيذ لعدم قدرة الحزب الأول على تأسيس أغلبية حكومية، فإن الفصل 98 جعل لهذه الأغلبية وجودا وشرعية دون ربطها بالحزب الأول، مما يجعل تأسيس الأغلبية وفق الفصل 98 مجالا مفتوحا يلزم فيه رئيس الدولة بالبداية فقط “أي إلزامية تكليف الحزب الأول بداية دون غيره”، لكنه لا يلغي العملية الانتخابية التي منحت للحزب الأول هذا الامتياز في حالة فشله، لكون الفصل 98 لم يشترط وجود هذا الحزب، ولأن من أصاغ الدستور كان يمكن أن ينص فيه على خيار الرجوع إلى الانتخابات دون إتمام آجال السنة إذا لم يتمكن الحزب الأول من تأسيس الأغلبية، لكنه فقط أشار إلى الأغلبية بشكلها الواسع ودون ربطها بالحزب الأول، أي أنه يمكن أن نتصور إمكانية وجود أغلبية بدون الحزب الأول، أي أن الفصل 98 ينص على حالة الاستحالة المادية المطلقة لإنشاء الأغلبية.
وفي إطار التماثل عرف المجلس الدستوري الفرنسي نقاشا مماثلا موضوع قرار له بتاريخ 30/12/79 مفاده أن الدستور لم يرتب نتيجة قانونية على إبطال قانون المالية، فطرح السؤال التالي: ماذا على البرلمان والحكومة أن يفعلا عند حالة البطلان؟ فكان جواب المجلس الدستوري أنه على كلا المؤسستين أن تقوما بصلاحياتهما لضمان استمرار السير الطبيعي للمؤسسات والإدارات الوطنية مستندا على القواعد المتعلقة بالحالات التي يتأخر فيها تقديم مشروع القانون المالي والتي كان منصوص عليها في نص دستوري آخر مستقل ولكن ضمن نفس المنظومة الدستورية أي تم تفسير فصل دستوري بفصل آخر.
وفي موضوع آخر رفض الرئيس الفرنسي سنة 1960 طلب أغلبية البرلمان الفرنسي لعقد اجتماع البرلمان، وأسس رفضه على أن الفصل الدستوري لا ينص الإلزام، لذلك فهل هناك نص إلزامي يلزم جلالة الملك بالعودة للانتخابات في حالة فشل الحزب الأول؟ أو يلزمه بعدم الانتقال إلى حزب آخر؟ وهذا الانتقال هل يجب أن يحترم فيه التراتبية أم أن مفهوم التراتبية ينحصر في الحزب الأول فقط؟ .
إن الدستور يتضمن مجموعة من القواعد الأخرى الغير المكتوبة والتي تجعل تفسير أي فصل دستوري يفرض علينا أن نأخذ بعين الاعتبار العلاقة بين الدستور والواقع، ولكن بنوع من السمو السياسي بإعمال القيم والأخلاق، وأما الحسابات الظرفية التي تحاول تقنين نص دستوري من أجل مكسب ظرفي قد يحد من سلطات وتحركات رئيس الدولة سيعرقل دوره الدستوري في السهر على حسن سير المؤسسات الدستورية من خلال تقزيم هذه الآلية التي هي وسيلة مثلى لحل الأزمات مستقبلا، هذا الدور الذي يماثله ما لرئيس الدولة من حق إعلان الحرب وحق حل مجلسي البرلمان وسلطة التحكيم بين المؤسسات، والتي هي حالات تنتج عن الأزمات، وكل ذلك دون أن نعني مطلقا أن يقوم جلالة الملك بوساطة بين الأحزاب السياسية لإيجاد حل سياسي، فالدور التحكيمي لجلالة الملك هو الإنصات لنبض المجتمع و تأسيس القرار الذي يراه في مصلحة البلاد، من خلال إعمال النص الدستوري بالشكل الذي يحل أزمة آنية ويبني سلوكا دستوريا للمستقبل، ولا معقب بعد ذلك احتراما لدور جلالة الملك في ضمان إيجاد حل للأزمة مع منح الموضوع زمنا دستوريا لتطوير العملية السياسية.
إن التعامل مع الفصل 47 بنوع من البراغماتية الحزبية الضيقة هو ضرب للعملية الدستورية كلها، وإلغاء للقاعدة التي نص عليها الفصل 98 كذلك ما لجلالة الملك من مكانة ودور وفقا للفصل 42 من الدستور.
إن التجارب التي نلاحظها حاليا في العالم كإسبانيا وغيرها تؤكد على أن لرئيس الدولة دور في تكريس العملية الديمقراطية باعتباره المسؤول الأول عنها، وهذا الدور تحكمه النصوص الدستورية بمجملها، وأن الدخول في مواجهات دستورية بناء على المصلحة الظرفية قد تهدد الثقة التي تجمع المؤسسات الدستورية بمختلف مكوناتها فيما بينما.
فتأسيس الديمقراطية ليس مرتبط بحالة محدودة في الزمن أو الشكل، بل هو تطور وحوار يضع حلولا بديلة قد لا ترضي الجميع، ولكنها تكون موضوع تجربة، تنطلق من حسن النوايا وتستند على الثقة ولو كان الأمر سيؤدي إلى تراجعات مرحلية، ولكنه سيحافظ على الاستقرار وسيساعد الأحزاب على بناء تصورات مشتركة.
إن التحكيم الذي من مهام جلالة الملك لا يمكن أن يكون موضوعه حسابات عددية لتأسيس أغلبية ما، ولكن دوره هو بلورة تصور دستوري يمنح حقا مكتسبا لهذا الحزب أو ذاك، مع إمكانية الانصراف على المكتسب في حالة الأزمة إلى حل بديل يكون له الأساس الدستوري.
نعتقد أن من مصلحة البلد أن يكون الهدف هو احترام المكونات الديمقراطية بنتائجها وأن يكون ذلك هو الهم الأساسي لأطراف العملية السياسية وليس التمسك بمكسب سياسي حزبي مرحلي ضيق، لأن الموضوع يظل دائما هو الوطن ويبقى الكرسي مجرد مكسب محدود في الحجم والزمن.
*محام وبرلماني